“العبودية المختارة” للكاتب”إتين دي لابويسي”
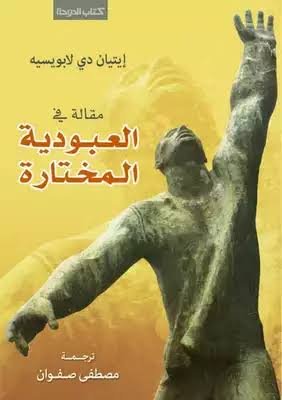
مقدمة:
يمكن تصنيف التيارات السياسية اليوم في العالم العربي في تيارين فكريين متعارضين؛ الأول يقول بأن الحرية تكمن في الدولة الحالية، ويشيد بالإصلاحات المعلن عن تحقيقها. ويقول الثاني أنها تتواجد خارجها، ويدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، سياسية واجتماعية واقتصادية حقيقية، ويؤكد أن الدولة الحديثة التي ورثناها عن الاستعمار تستعبد الإنسان اليوم بحكم قوتها، ولا فرق بين عبودية الأمس واليوم إلا في أن عبودية اليوم تتم بطرق حديثة، إذ الأكثرية الفقيرة والمعدومة مغلوبة على أمرها وتابعة ومستعبدة من طرف أقلية جد قليلة تحتكر الأموال والثروات وتسيطر على وسائل الإنتاج، وعلى الدولة والاقتصاد، وتفقد الناس حقوقهم الطبيعية في الكرامة والشغل والصحة والتعليم، وتعمل على إفساد المجتمع وتطويعه وتدجينه بمختلف الوسائل. وهذا التيار يذهب إلى ما ذهب إليه “لابويسي” من أن العلاقات السياسية الحقة هي تلك التي لا تنبني على الطاعة والوفاء والولاء للحاكم، ومن أن السياسة الحقة، تشترط الوعي والحرية وهو ما ينعدم حقيقة في دولنا التي تحكمنا اليوم في عالمنا العربي. يقول “لابويسي” الشاب الذي لم يخص الطغيان بنظام معين أو زمان محدد:” فالطغاة ثلاثة أصناف، البعض منهم يمتلك الحكم عن طريق انتخاب الشعب، والبعض الآخر بقوة السلاح، والبعض الثالث بالوراثة المحصورة في سلالتهم.” وفي هذا القول صورة لما نحن عليه داخل كهوفنا، ولا فرج لنا إلا حتى نغيّر ما بأنفسنا تصديقًا لقول الله تعالى: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. ويتساءل لابوسي إن كان ثمة دوافع نفسية ما تدفع الناس إلى القبول بالعبودية والطاعة.
سنحاول في هذا العمل، التطرق إلى التساؤلات التي طرحها “لابويسي”، وحاول مقاربتها، وذلك كما يلي: أولاً: سيد واحد يكفي،ثانيًا: استعباد الإنسان،ثالثًا: تحرر الإنسان.
أولاً: سيد واحد يكفي
كتب “إتين دي لابويسي” كتابه “العبودية المختارة” عام 1548، في وقت تمر به فرنسا بأزمة خانقة تميزت بالظلم والاستبداد، وتطرق فيه إلى خضوع الناس لنظام حكم الفرد الوحيد، فتساءل عن طبيعة الإنسان وعلاقته بالنظام السياسي المستبد والمستعبِد للناس، وتطرق كذلك إلى العلاقات الاجتماعية والدواعي النفسية التي توطد الظلم والطغيان وترسخ الطاعة والعبودية. وقد انطلق “دي لابويسي”، في كتابه الذي اتخذ شكل مقال، بكلمات من خطاب “أوليس” الذي قال: “كثرة الأمراء سوء، يكفى سيد واحد”، وقد أراد بقوله ذاك أن يهدئ الجيش، حسب “لابويسي”، لا أن يقول الحقيقة، لأن الحقيقة هي أن الخضوع لسيد واحد لا يقل خطرًا عن الخضوع لأمراء كثر، ويقول: “بيد أن “أوليس” ربما وجبت معذرته إذ لم يكن له مفر من استخدام هذه اللغة حتى يهدئ ثورة الجيش مطابقًا بمقاله المقام، بدل مطابقة الحقيقة، فإن وجب الحديث عن وعي صادق، فإنه لبؤس ما بعده بؤس أن يخضع المرء لسيد واحد يستحيل الوثوق بطبيعته أبدًا، ما دام السوء في مقدوره متى أراد، فإن تعدد الأسياد تعدد البؤس الذي ما بعده بؤس.”
انتقل “دي لابويسي” بعد ذلك مباشرة إلى طرح إشكاليته التي يمكن تلخيصها في التساِؤل التالي: لماذا يقبل الناس بالعبودية مع العلم أنهم ولدوا أحرارًا؟ يقول “لابويسي” متسائلاً: “فأما الآن فلست أبتغي شيئًا إلا أن أفهم كيف أمكن لهذا العدد من الناس ومن البلدان ومن المدن ومن الأمم، أن يحتملوا أحيانًا طاغية واحدًا.” وهو سؤال محير حاول الفيلسوف “إتيين دي لابويسي” مؤسس علم السياسية الحديث الإجابة عنه، إنه السؤال الذي حير العقول منذ زمن بعيد، ولم يلقَ إجابات شافية إلى اليوم.
ثانيًا: استعباد الإنسان
يقول”لابويسي”: “إننا لا نولد أحرارًا وحسب، بل نحن أيضًا مفطورون على محبة الذود عن الحريّة”، ودليل ذلك: “إننا نندهش إذ نسمع قصص الشجاعة التي تملأ بها الحرية قلوب المدافعين عنها.” فالحرية إذن طبيعة بشرية متأصلة في ذات الإنسان ووجدانه، إذ أثبت التاريخ قوة الشعوب غير المتناهية في الدفاع عن نفسها، وإن كلفها ذلك حياتها في نضالها من أجل الحرية ضد الاستعمار، فهي بحكم فطرتها توّاقة إلى الحرية والتحرر، وتنفر بحكم طبيعتها من قيم الطاعة والعبودية. لكن كيف نفهم بالمقابل خضوع هؤلاء إلى حاكم وحيد طاغٍ؟ يقول: “إننا نندهش إذ نسمع قصص الشجاعة التي تملأ بها الحرية قلوب المدافعين عنها، أما ما يقع في كل بلد لكل الناس كل يوم، أن يقهر واحد الألوف المؤلفة ويحرمها من حريتها، فمن يصدقه لو وقف عند سماعه دون معاينته؟”
إذا كانت الحال كذلك، فلابد أن هناك أسبابًا خفية ودوافع ما قد نجهلها، تجعل الإنسان يتنازل عن الحرية ويرضخ للعبودية والإذلال، فالأمر عارض طارئ على الطبيعة البشرية وغير متأصل فيها، وحالة مرضية تحتاج إلى علاج. ويذهب “دي لابويسي” إلى أن الحاكم الطاغي ضعيف وذليل، ويقول: “هذا العدو الذي يسودكم إلى هذا المدى، ليس له إلا عينان ويدان وجسد واحد، وهو لا يملك شيئًا فوق ما يملكه أقلكم على كثرة مدنكم…إلا ما أسبغتموه عليه من القدرة على تدميركم.” وهو ليس بقائد حرب ولا زعيم، بل ليست له حتى مواصفات الرجال، فهو يعاني من الجبن ومن التخنث، يقول “لابويسي”: “واحد لا هو بهرقل ولا شمشون بل خنث، هو في معظم الأحيان أجبن من في الأمة وأكثرهم تأنثًا، لا ألفة له بغبار المعارك… وهو لا يحظى بقوة يأمر بها الناس، بل يعجز عن أن يخدم ذليلاً أقل أنثى، أنسمي ذلك جبنًا؟”، من الممكن تسميته كذلك. لكن “أنقول إن خدامه حثالة من الجبناء؟ لو أن رجلين، لو أن ثلاثة أو أربعة لم يدافعوا عن أنفسهم ضد واحد لبدا ذلك شيئًا غريبًا، لكنه بعد ممكن لو وسعنا القول عن حق أن الهمة تنقصهم. ولكن لو أن مئة، لو أن ألفًا احتملوا واحدًا ألا نقول إنّهم لا يريدون صده، ليس لأنهم لا يجرؤون على الاستدارة له، لا عن جبن بل احتقارًا له في الأرجح واستهانة بشأنه؟ فأما أن نرى لا مئة ولا ألف رجل، بل مئة بلد، ألف مدينة، مليون رجل، أن نراهم لا يقاتلون واحدًا…أهذا جبن؟”
فهل السبب هو جبن هذه الشعوب وخوفها؟ يقول “لابويسي” في محاولة تفسير خوف الإنسان: “فلقد يخشى اثنان واحدًا ولقد يخشاه عشرة. فأما ألف، فأما مليون، فأما ألف مدينة، إن هي لم تنهض دفاعًا عن نفسها في وجه واحد فما هذا بجبن، لأن الجبن لا يذهب إلى هذا المدى، كما أن الشجاعة لا تعني أن يتسلق امرؤ وحده حصنًا أو أن يهاجم جيشًا أو يغزو مملكة. فأي مسخ من مسوخ الرذيلة هذا الذي لا يستحق حتى اسم الجبن ولا يجد كلمة تكفي قبحه، والذي تنكر الطبيعة صنعه وتأبى اللغة تسميته؟” ليس السبب هو الخوف، فماذا يكون إذن؟ فالحاكم الطاغي يستبد بهم ويستعبدهم كما شاء، وكيف شاء، وهم الأكثر عددًا والأكثر قوة، وهم المعروفون بالحرية والنضال من أجلها؟ أليس هذا تناقض مريع في نفسية هؤلاء؟ هل يعد هؤلاء سليمو النفسية؟ ألا يعانون من مرض ما أو جنون؟ وإلا كيف تقبل الشعوب السليمة والسوية بالعبودية بدل الحرية؟ أليس هذا ضد العقل والمنطق والطبيعة الإنسانية؟ وكيف يمكن للناس إذن القبول بالعبودية بدل الحرية، وهم الأكثر قوة والأكثر عددًا مع كون الطاغي الذي يستعبدهم الأكثر ضعفًا ووهنًا، كيف تقبل بذلك، إلا في حالة واحدة استثنائية مرضية وغريبة عن الطبيعة الإنسانية، وهي أن تكون هي راغبة فيها؟
معلوم أن هذه الشعوب فقدت طبيعتها وأصبحت مريضة وغير سوية، حسب “لابويسي” إذ يقول: “أن يحتملوا أحيانًا طاغية واحدًا، لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا القدرة على الأذى، إلا بقدر احتمالهم الأذى منه، ولا كان يستطيع إنزال الشر بهم لولا إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته.” ويرجع “لابويسي” إلى البحث في الطبيعة التي أظهرت في نظره اختلافات وتمايزات بين البشر من حيث قدرتهم وكفاءتهم العقلية، ومن ثمّ فهو يقسم الشعوب إلى شعوب متحررة وأخرى مستعبدة ترضى بالطغيان وتستسلم له وتتكيف معه.
ثالثًا: تحرر الإنسان
يرى “لابويسي” أن الطبيعة لم ترسل الأفراد الأكثر قوةً وذكاءً ليكونوا عصابات مسلحة في الغابات، ليقهروا ويضطهدوا الضعفاء من الناس، فليس هناك حق طبيعي في حكم الناس وإخضاعهم. كما أنّ السلطة ليست أمرًا طبيعيًا، يفرضها الوجود ويوجب الطاعة والخنوع. فاللامساواة الطبيعية بين البشر لا تقضي بحكم الضرورة إلى الغلبة والسيطرة، وإلى التفريق بين الحكام والمحكومين، وإلى خلق علاقات سلطوية في المجتمع. وهو ما ينطبق على الدولة في نظره، وإلا فلماذا تتواجد الدولة في كل مكان وزمان؟
يرى “لابويسي” أن الدولة تتواجد لأن هناك فئات لها مصلحة في تواجدها، لذلك فالإنسان في نظره، يمكن أن يتمرد على الظلم والطغيان، ليسترجع حريته. لكنه قد يخضع لحقب طويلة، للذل والاستعباد، لأن ذات الإنسان مضطربة، تتجاذبها نزعات متناقضة، بين الحرية والعبودية. يقول: “حينما يتحوّل أحد الملوك إلى طاغية فإن كل ما في المملكة من شرّ ومن حثالة، يجتمعون من حوله ويمدّونه بالدعم لينالوا نصيبهم من الغنيمة… وحين أتفكر في هؤلاء الناس، الذين يتملقون الطاغية، من أجل أن ينتفعوا بطغيانه وبعبودية الشعب، يتولاني الذهول حيال شرّهم، بقدر ما تنتابني الشفقة حيال غبائهم، فهل يعني تقرب المرء من الطاغية في الحقيقة شيئًا آخر سوى ابتعاده عن الحرية واحتضانها بالذراعين؟” من هنا يرتمي الإنسانكلياً في أحضان عبوديته. فإذا ما التقى الأشرار فإنهم لا يؤلِفون مجتمعاً بل مؤامرة، وهم لا يتحابون بل يخشى بعضهم بعضًا، وليسوا أصدقاء، بل هم متواطئون… أيها الرب الحق، كيف يكون المرء منشغلاً ليلاً ونهارًا بإرضاء رجل، ويحذر منه ويخشاه أكثر من أي شيء في الدنيا. لكن هل يمكن لحاكم عاقل وسوي وحر استعباد شعبه إذا لم يكن هو نفسه مستعبدًا من طرف ذاته؟
إنّ الحاكم الطاغي، كما يرى “لابويسي”، ليس سيد نفسه، بل سجين طغيانه ولا يستطيع التحرر من سجنه، فلا يمكن أن يغير سلوكه. ويذهب “لابويسي” إلى أنّه لا يمكن للحاكم العاقل الحر استعباد شعبه، إلا إذا كان يعيش حالة الاستعباد ذاته، فهو شخص غير طبيعي في خوف دائم من شعبه يلجأ إلى الترهيب والعنف لقمع الاحتجاجات والتمردات، ويسعى إلى تقوية سلطته بالقوة والحيل، والكذب والإعلام الفاسد، والمهرجانات المنحطة والحفلات الشعبية السخيفة، لتخدير الناس وتنويمهم، ويعيش في عزلة دائمة عن الناس، لا كرامة له ولا أخلاق، يمتاز سلوكه بالتعالي والاستعلاء، ويحث الناس على تقديسه والركوع له وعبادته، فهو فوق القانون وفوق التاريخ، ولا يمكن محاسبته أو مساءلته وكأنه إله يسمو فوق البشر. فما هي السبل للتحرر منه؟ كيف يمكن القضاء على النظام الطغياني؟ وكيف يمكن أن تسترجع الشعوب حريتها وترجع إلى طبيعتها وتشفى من مرضها؟
يقول “لابويسي” متسائلاً عن سبب قبول الناس بالعبودية وسكوتهم عنها، محرضًا الشعوب، لتقوم بالعصيان المدني، لاسترجاع حريتها: “لكن ما هذا يا ربي؟ كيف نسمي ذلك، أي تعس هذا، أي رذيلة، أو بالأصدق أي رذيلة تعسة؟ أن نرى عددًا لا حصر له من الناس، لا أقول يطيعون، بل يخدمون، ولا أقول يحكمون، بل يستبد بهم، لا ملك ولا أهل ولا نساء ولا أطفال، بل حياتهم نفسها ليست لهم.”
وقد اقترح “لابويسي” حلولاً، لمواجهة سطوة الطاغية، ووضع حد لحكمه، يقول في هذا الصدد: “يبقى القول منحصرًا بشأن هذا الطاغية وحده، فهو لا يحتاج إلى محاربة، وليس ثمة ما يدعو للقضاء عليه، فهو مقضي عليه تلقائيًا، بشرط ألا يَقبل البلد أن يكون مستعبَدًا له، وليس المقصود انتزاع أي شئ منه، بل عدم منحه أي شيء، هي الشعوب إذن التي تستسلم بنفسها لسوء المعاملة، لأنها إذا تخلت عن خدمته، تصبح متحررة…كذلك هي حالة الطغاة، فكلما نهبوا وكلما ازداد الإغداق عليهم، تشتد سطوتهم…أما إن لم يعطوا شيئًا، ولم تقدم لهم فروض الطاعة، فإنهم، ومن غير قتال أو توجيه ضربات، سيلبثون مجردين مسحوقين، ولا يبقى لهم من كيان، فحالهم كحال الغصن حين تنقطع عنه العصارة التي تغذيه من جذوره، فيجف ويموت.
ليس الحل بمقاومة الطاغي بالسلاح، يقول “لابويسي”: “فما أسألكم مصادمته أو دفعه، بل محض الامتناع عن مساندته.” لأن الطغيان لا ينتهي بموت الحاكم الطاغي أو اغتياله، ولأن الطغيان، يرتكز على نظام اجتماعي متراتب المستويات، كل مستوى مترابط مصلحيًا بالمستوى الأعلى منه. يقول “لابويسي”: “حينما يتحوّل أحد الملوك إلى طاغية، فإن كل ما في المملكة من شرّ ومن حثالة، يجتمعون من حوله ويمدّونه بالدعم لينالوا نصيبهم من الغنيمة.” ويضيف: “إذا ما التقى الأشرار فإنهم لا يؤلِفون مجتمعًا بل مؤامرة، وهم لا يتحابون، بل يخشى بعضهم بعضًا، وليسوا أصدقاء، بل هم متواطئون.”
ويكمن الحل في أن يريد الناس الحرية فقط، وأن يتوقفوا عن دعم الحاكم الطاغي، وعن التواطؤ معه ودعمه بالعتاد والأموال والقوة، وأن يتوقفوا عن خيانة أنفسهم، فهو يحاربهم بأموالهم وأبنائهم “أي قدرة له عليكم إن لم تكونوا حماة للّص الذي ينهبكم، شركاء للقاتل الذي يصرعكم، خونة لأنفسكم؟” يدعو “لابويسي” “الرعايا” بأسلوب نضالي إلى هجر واقعهم الذي لا ترضى به البهائم، ناصحًا إياهم بالتأكيد على أن مجرد الرغبة في التغيير تعطي أكلُها، يقول: “إنّ بوسعكم التخلص من تلك الموبقات الكثيرة التي لا تقوى البهائم على تحملها لو كانت تحس بها، إنّ بوسعكم التخلص منه إذا سعيتم… لاتسعوا إلى التخلص منه، بل أعربوا عن الرغبة في ذلك فقط، احزموا أمركم على التخلص نهائيًا من الخنوع وها أنتم أحرار. أنا لا أريد منكم الإقدام على دفعه أو زحزحته، وإنما الكف عن دعمه فقط، ولسوف ترونه مثل تمثال عملاق نزعت قاعدته من تحته، كيف يهوي بتأثير وزنه فيتحطم.
كما يرى “لابويسي” أن لا مناص للتحرر من الطغيان من اللجوء إلى عصيان مدني والقيام بثورة سلمية ستؤدي إلى تفكيك البنى الاجتماعية التي يرتكز عليها الطغيان السياسي، وهذا لن يتأتى إلا بتغيير مستوى الوعي السياسي للإفلات من الطغيان واسترجاع الحرية المفقودة.
خاتمة:
على الرغم مما ذهب إليه “مونتني” وهو صديق صاحب الكتاب، من أن الكتاب فلسفي ومتعالٍ على التاريخ، إلا أن قراءة المقال قراءة شاملة تجمع بين النص والتأمل في الظروف التاريخية التي كتب فيها، وكذا بالرجوع إلى سيرة المؤلف، تؤكد على أن المقال بيان سياسي موجه ضد النظام الملكي بأوروبا في القرن السادس عشر الميلادي، إذ شكّل وجهة نظر وتأمّل في السياسة وفي أسباب الطغيان والطاعة، ونظرية سياسية قريبة من النظريات الحديثة في الطغيان السياسي، لأنه اهتم بالدوافع النفسية المحددة للسلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد والجماعات، الأمر الذي جعل كثيرًا من المحللين يتساءل عن الدواعي الفكرية والسياسية التي دفعت “لابويسي” إلى تأليف كتابه هذا في ذاك الوقت بالذات، فثمة من ذهب إلى أنه وضع كتابًا ضد كتاب الأمير لـ”ماكيافيلي” ونظريته حول الاستبداد، لكن في الواقع، لا يمكن إثبات الطابع الاستبدادي لهذا الكتاب، إذ إن الظروف التي كتب فيها كانت تتسم بعدم الاستقرار. وهناك من ذهب إلى كونه مؤلف سياسي ضد الملكيات المطلقة والمدافعين عنها، بدليل عدم السماح بنشره في ذلك الوقت. وهناك من ذهب إلى كونه ضد المدافعين عن الأنظمة الملكية المطلقة، ومنهم “كلود دي سايسل” صاحب كتاب “الملكية الفرنسية العظمى”. إلا أن ما يمكننا تأكيده أن الظروف السياسية المتقلبة آنذاك، بالإضافة إلى القمع والطغيان المسلط على الشعب له علاقة واضحة بالأوضاع السياسية بفرنسا وقتها، ومعلوم أن تلك الظروف هي ما أثّر في “لابويسي” ودفعه ليكتب كتابه ذاك.
لموبايلي عبد الصمد صابر.
مؤسسة مؤمنون بلاحدود-موقع حزب الحداثة

