الزمن في المشروع الشعري الحداثي عند ادونيس (٢)
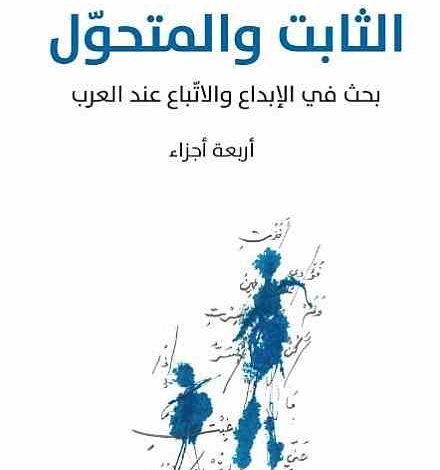
من الثابت إلى المتحوّل.
مثَّل التحوّل من الجماليّة الشفويّة إلى الجماليّة الكتابيّة لحظة الحداثة الأولى عند أدونيس، وهو التحوّل الذي بُنى على القرآن والدراسات القرآنية – كما قدّمنا – والذي أتى بلغةٍ وجماليّات ومعرفةٍ جديدة، غير أن الثبات والارتكان إلى النص القرآني باعتبارهِ يحمل معرفة نهائيّة؛ أدّى بلحظة الحداثة هذه إلى تحوّلها إلى ثابتٍ. إذ يجب – وفقًا لأدونيس – التحوّل من هذه اللحظة التي قدّمت معرفةً جديدة إلى البناء عليها وتجاوزها إلى لحظةٍ حداثيّةٍ أخرى، ليصير الثابت متحوِّلا. وليتحوّل الاتّباع إلى إبداع. إذ إن جوهر الإبداع هو التباين والاختلاف وليس التشابه والتماثل. والعودة إلى الماضيّ والجذور يجب أن تتمثّل في العودة إلى الإبداع كعمليّة مستمرّة، وليس في العودة إلى الأشكال التي تم إبداعها، وهو ما يعني بالضرورة تجاوز الماضي. فالعالم الشعريّ لم يُخلق دفعة واحدة في نقطة زمنيّة اسمها الماضي أو التراث، وإنما هو انفتاحٌ دائم وقابليّة مستمرّة على أن يكون أكثر غنىّ وجمالا، فالكمال حركةٌ لا تكتمل.[20]
الثابت هو ما لا وجود لعنصر الزمن فيهِ. وهو – وفقًا لأدونيس – الفكر الذي ينهض على النص، ويتّخذ من ثباته حجّة لثباتهِ هو، ويفرض نفسه بوصفهِ المعنى الوحيد الصحيح لهذا النص، وبوصفهِ يمثّل سلطة معرفيّة. بينما المتحوّل هو الفكر الذي ينهض هو أيضًا على النص، ولكن بتأويلٍ يجعل النص قابلًا للتكيُّف مع الواقع وتجدده، أو الفكر الذي لا يرى في النص أي مرجعيّة، ويعتمد أساسًا على العقل لا النقل.[21]
المتحوّل إذن هو المتغيّر الدائم والمستمرّ الذي ينتبه لوجوده في إطار عامل الزمن الذي يؤدي إلى تجديد الحياة والواقع، ما يستلزم بالضرورة تجديد وتطوير المعرفّة والشعر بما يتناسب مع هذه التغيّرات الزمنيّة باعتبار الإنسان كائن زمنيّ يعيش داخل الزمن.
هذا الفهم – وفقًا لأدونيس – لم يأتي فقط مع لحظة تلاقي السياقيّن العربيّ والغربيّ في بدايات القرن التاسع عشر. فمساءلتهُ للتراث – كما أسلفنا – أسئلةً حداثيّة عملت على تجذير الحداثة كمفهوم لغويّ ديني – من حيث هو الإحداث والابتداع- وإثبات تواجده في السياق العربيّ القديم؛ من حيث هو الخروج على القديم أو الأصوليّ والدينيّ، وهي حداثة عربيّة تختلف – من حيث الاصطلاح – عن الحداثة الأوروبيّة. غير أن هذه الحداثة العربيّة لم ترتبط بعامل الزمن في تكوينها الأساسيّ – كما يؤكّد أدونيس بنفسه – فالحداثة العربيّة في سياقها القديم لم تتواجد كخطٍ متصلٍ أفقيّ، وإنما انبجاساتٍ متقطِّعة، ولحظات آنيّة، لكنها بدأت في القرن الثامن الميلاديّ واستمرّت حتى سقوط بغداد.[22]
الحداثة بهذا المعنى تختلف جذريًا عن الحداثة بمفهومها الأوروبي الحديث من حيث هي لحظة الانقطاع عن الماضيّ ولحظة البدء في التجدد المستمرّ، وهو المعنى الذي ينظِّر له أدونيس في مفهوم (المتحوّل).
مفهوم الحداثة إذن الذي يبحثه أدونيس في التراث يختلف إذن بين النموذجين الأوروبي الحديث والعربي القديم. بل إن استخدام مصطلح الحداثة بمعنى الإحداث أو الابتداع – بكل ظلالهِما الدينيّة – يحمل تحويرًا ولويًا للتراث ليتماشى مع النموذج المقدّم ويتماشى معه، وهو النموذج المتأثِّر بالحداثة الأوروبيّة.
عمل أدونيس كذلك على ربط الأشكال المختلفة للأدب العربيّ القديم في ظهورها – كما عند المعرّي والنفري وأبي نواس وأبي تمام- بلحظة معيّنة هي القرن الثامن. غير أن هذه النماذج لم تمثّل تيَّارًا مطلقًا مستمرًا عمل على إحداث قطيعةٍ مع الماضي، بل تجاورت معه تيارات تقليديّة ونماذج موروثة عملت على إحداث تطويرًا في الشعر دون أن تمثّل خروجًا على الأصول كما عند المتنبيّ (915-965) وبن الرومي (836-896) على سبيل المثال، إذ أن تجديدهما في الشعر – في أشكالهِ القديمة – يخرج تمامًا عن النموذج التفسيري الذي يقدّمه أدونيس. فلم يستلزم تجديدهما الإتيان بالشكل الحداثيّ –بمفهومهِ الأدونيسي – من حيث التجديد على مستوى اللغة والمعرفة والشكل والجماليًات، وإنما على العكس أتى تجديدًا على مستوى الحسّ والشعور، واللغة من حيث هي ألفاظ وليس من حيث هي نظمٌ ومواضع للكلم.
يستمر أدونيس في نمذجتهِ لمفهوم الحداثة الشعريّة، ويعطي مثالًا للتجديد في السياق الشعري العربيّ بما هو ليس تقليدًا للتراث ولا اتباعًا للغرب؛ فيأتي نموذج القصيدة الشبكيّة/ الشجرة/ العمارة الذي وضعه للتدليل على الإحداث الشعري، والإبداع الحداثي.
من قصيدة التفعيلة إلى القصيدة الشبكية.
لأدونيس مفهوم مُحدد ودقيق عن الحداثة الشعريّة يربطه بالتجديد والإبداع على مستوى اللغة والجماليّات والمعرفة. وهو من هذا المنطلق يرفض الحداثة في ارتباطها باللحظة الحديثة أو الراهنة فقط، دون أن يرافق هذا الارتباط تجديد وابتكار. كما يرفض تعريف الحداثة من حيث هي تقليد ومماثلة الغرب أو الاختلاف عن القديم فقط، ويرفضها كذلك إذا عنت التشكيل النثريّ فقط، أو الاستحداث المضموني بإدخال ألفظ واختراعات حديثة على الشعر. [23]
يتجاوز أدونيس قصيدة التفعيلة التي تُبنى على شكلٍ محدد، وأوزانٍ، لأسبابٍ عديدة – في رأينا – منها ثبات شكلها برغم مرونته، وانتاجها تأثّرًا بالغربِ ونقلا عنه، وعدم تجاوزها للوزن والتفعيلة. وفي مقابل هذا يرسي أدونيس مفهوم البنية الشبكية أو الشجريّة؛ وهي القصيدة التي تمتد جذورها في جميع الأنحاء، وتقدّم شريحة كاملة عن المجتمع والتاريخ، وتكون بمثابة عمارة تدخل إليها وتتطلّع من نوافذها. وهي كذلك القصيدة التي تشبه إلى حدٍ ما شاشة السينما التي تعطي في لحظة واحدة وفي فترة زمنيّة معينة؛ شريحة تشكيليّة وموسيقيّة وغنائيّة وصوتية.[24] وهو ما انعكس في قصائد مثل (هذا هو اسمي)، (مفرد بصيغة الجمع)، (قبر من أجل نيويورك)،[25] وغيرها.
علم جمال المتحوّل – كما يُحدده أدونيس – يردّنا إلى القصيدة البديعة الصنع، كصورةٍ جديدة عن العالم من صورٍ ممكنة لا نهاية لها.[26] غير أن هذه التصوّرات تؤديّ إلى الغموض والحاجة إلى التأويل نتيجة اهتزازات الصورة الثابتة في نفس القارئ كنتيجةٍ لاهتزاز العلاقّة بين الدال والمدلول.[27] وهو ما يؤدّي – في رأينا – إلى أن القصيدة يمكن تأويلها لتقول كل شيء، كما يمكن النظر إليها على أنها لا تقول شيء. فالغموض هنا لا يؤسس على غموض المعنى المقصود، وإنما كذلك على غموض دلائل اللغة التي توصل للمعنى، اعتمادًا على لغةٍ شعريّة تبدأ من الفراغ- الموت بين الأسماء القديمة للأشياء وأسمائها الجديدة، كما يعرّفها في أحد كتبهِ.[28] هذا الغموض الذي يجعلنا نتساءل عمّا عناه بالإتيان بلغةٍ جديدة، وهل تضمن هذا تحوير دلائل الكلمات ليدلل بها على أشياء جديدة، أم قطع الصلة بين الدال والمدلول؟
الشعر الحداثيّ إذن هو ليس شعرًا غامضًا أو رمزيّ، بل هو يقترب – بهذا المعنى – من السرياليّة، التي أدّت إليها النظر إلى الشعر كحركةٍ تنقل دلائل الكلماتِ من أفقٍ لآخر فيما تخلق للمعنى فضاءًا آخر. فهي كتابة – إضافة إلى كل هذا – تهتمّ بالخفي الباطن مقابل الظاهر والواضح، وبالاحتمالي والتخييلي، مقابل اليقيني العقلاني. هكذا يتحرّك القارئ في التخييلي والاحتمالي، فيما يتحرّك في نفس الوقت داخل كتابة خارج كل نمذجة، ولا مرجعيّة لها في الماضي.[29]
هذا الموقف الذي يراه البعض يمثّل قطيعةٍ بين النص الشعريّ والمتلقي؛ إذ لا تغدو العلاقة بينهما خاضعةً لأي معايير تُمكّن من التواصل؛[30] يعمل على إحداث فجوةٍ عميقةٍ بين النص وبيئتهِ ومتلقيه، وهو قد يؤدي في النهايةِ إلى انعزاليةِ الفن والشعر. فرغبة أدونيس في الإتيان بكلامٍ مطلقٍ عبر نصٍ “يعبّر عن شيءٍ هو كل شيء، ولا يغلق عليه، وإنما يفتحه إلى مالا نهاية”[31] أدّت إلى شعرٍ تجريديّ يعمل على تحطيم الموضوع ويُفضي إلى تشذّره وغيبته.[32]
هل الحداثةُ هوس يجب أن نُصاب بهِ، أم هي وعيُّ متطوّر نوظّفه فيما يلائم واقعنا لنسد حاجاتنا المختلفة؟ يُغفل أدونيس –في رأينا- وهو يُنظِّر للشعريّة الكتابيّة؛ حقيقة ارتباطها بالواقع العربيّ المعاش، وبدء التحوّل من الحياة البدويّة إلى الحياة الحضريّة، وإلى بدء انتشار الكتابة كبديلٍ للنقل الشفوي اللسير والأخبار، وهو ما ترافق مع تدوين القرآن، وتدوين الشعر الجاهليّ كذلك حفظًا له من الضياع. وهو ما عمل على تغيّر جماليات الشعر المكتوب عن الشعر المنقول شفويًا. بالتالي ارتبط التطوّر الجمالي – في السياق العربي – بتطورٍ موازٍ على السياق الاجتماعي والثقافي، ولم تؤد له حادثة الوحي ونزول القرآن الكريم مباشرةً. هذا الفهم الذي يعطي للحياة الاجتماعيّة المساحة الكافيّة لاستيعاب مراحل التطوير والتغيير في الأدب، قبل تقرير الحاجة إلى الانتقال إلى خطوة جديدة في طريق التطوير؛ يغيب تمامًا عن النموذج الحداثي الشعريّ الذي يعرضه ويجادل به.
يُنهي أدونيس كتابه المهم عن الثابت والمتحوّل قائلا: بعد الإعصار الذي يمحو حدود الأنواع من على خريطة الكتابة، يجيءُ الهدوء. ثمّةُ حاجةٍ إلى الدخول في تحديدٍ جديدٍ لكتابةٍ جديدة.[33] والسؤال الذي يبدو لنا هو: هذه الحاجة الجديدة للدخول في كتابة جديدة؛ حاجة لمن؟ من يحتاج هذا الدخول في مرحلةٍ جديدة للكتابة؟ هل هي حاجة الشاعر وحدة في انفصالهِ عن بيئتهِ؟ هل هي حاجة الشاعر في اتصالهِ ببيئتهِ؟ هل هي حاجة المجتمع أو المتلقيّ نفسه؟ لا يخبرنا أدونيس تحديدًا، لكننا نفهم أنها حاجة الشاعر الذي يقود عملية الحداثة ويجعلها مستمرةً كهوسٍ لا نهاية له. وهو ما أدّى بشعر أدونيس نفسهَ لا لأن يكون غير مفهومًا فقط، وإنما غير مقروء أيضًا، إذ أن بعض قصائده لا يمكن قراءتها بشكلٍ صحيحٍ إلا بعد أن يقوم أدونيس نفسه بإلقائها على جمهورهِ، فضلا عن فهمها.[34] وهو ما يجعلنا نتساءل بكثيرٍ من الدهشة عن الفرق بين الجماليّة الشفويّة، والجماليّة الكتابية.
يأتي هذا الهوس بالتغيير والتطوير والتجديد المستمر كحالة شعوريّة لا تهدأ ولا تركن إلى معرفةٍ أو نموذجٍ أو شكلٍ أو لغةٍ؛ من ذات الحالة الشعوريّة للحداثة الأوروبية التي وصفها شبنجلر من أنها حضارة الرجل الظامئ أبدًا إلى المعرفة، والذي لا يرتكن إلى حقيقةٍ إلا لينطلق بحثًا عن حقيقةٍ أخرى. وإذا كان لهذا الموقف في سياقهِ الأوروبيّ ما يبرره – نتيجة الثورة على الكنيسة بما كانت تقفه من موقفٍ برجماتيّ نفعيّ في تحديد الحقيقة المطلقة- فإننا نتساءل بدهشةٍ عما يبرر نقله إلى سياق الشعر العربي، أو إلى سياق الشعر عمومًا.
إن موضعة الحاجة الدائمة إلى التطوير على السلّم الزمنيّ، وليس السلم الاجتماعي؛ يؤدي إلى تسارعٍ دائمٍ – بلغة هارتموت روزا Hartmut Rosa (1965- ) للحداثة الشعريّة، والشعور الدائم بالتناقص المستمّر لمدّة الأحداث أو الأشكال الشعريّة المتتاليّة دون أن يتم استيعابها بشكلٍ كافٍ. ويؤدي نموذج المتحوّل كذلك –كنموذج فكريّ للحداثة الشعريّة- إلى دخول الشعر حقل التغيّرات الهادرة التي أدى إليها التسارع التقني والتكنولوجي، ونقلها إلى الحقل الشعريّ/ الفنّي كمنطلق فكريّ.
يشرح روزا مفهوم التسارع الاجتماعي كظاهرة أساسيّة في مجتمع الحداثة ترتبط ارتباطًا ديناميكيًّا بمنطق النمو الكمّي، ويضمِّنه ثلاثة أبعادٍ مختلفة؛ التجديد التقني والتكنولوجي، والتغيير الاجتماعي – خاصّة مؤسسات العمل والأسرة – وإيقاع الحياة. في هذا الإطار تحوّل الثبات إلى تراجعٍ؛ فمن لا يتقدّم يتأخّر نتيجة تغيّر وتقدّم السياق والمحيط الاجتماعيّ.[35] من هنا كان الخوف الأكبر – في ظننا – في المجتمع الحداثيّ هو الخوف من الشعور بعد التماشي feeling irrelevant مع المجتمع الصاعد أبدًا، ومع نقص أوقات الفراغ-كما يقول روزا- أدى هذا في النهاية إلى انتشار صناعات اللهو، والثقافة الاستهلاكيّة.
في هذا الإطار، كيف يمكن لمتلقي الشعر أن يواكب تسارعًا آخر على المجال الشعريّ أو الفنيّ يلغي حدود اللغة، ويفكك ما بين الدال والمدلول من علاقةٍ ويأتي بنماذجٍ متغيّرةٍ على الدوام، في هوسٍ مستمرٍ لا يتوقّف بحثًا عن حقيقةٍ غير مطلقةٍ لا يتم الوصول إليها؟ وهو ما قد أدّى في النهاية إلى انعزال الشعر عن المجال الثقافي والاجتماعي.[36]
إننا نميل إلى الظنّ بأن استجلاب النموذج الفكريّ الحداثيّ الأوروبي وتطبيقه على الشعر، ثم محاولة ليّ التراث لتحميله بهذا النموذج هو جوهر المشروع الفكريّ الحداثيّ عند أدونيس. وقد يكون هذا مقبولًا عند البعض، لكن الفجوة الرهيبة التي يغفل عنها هذا المشروع هو كيفية موضعتهُ في سياق المجتمع الحديث –غربًا أو شرقًا- ومدى الحاجة إلى مثل هذا المشروع الشعريّ على المستويين الاجتماعي والثقافي. كذلك غفل المشروع الفكريّ عن تضمين المتلقي أو الجمهور أو حركته ضمن إطار هذا المشروع الذي يبدو مشروعًا فرديًا للشاعر دون بيئتهِ.
خاتمة
ننتهيّ إذن من خلال قراءتنا للمشروع الشعريّ الحداثي عند أدونيس إلى اعتبار عامل الزمن عاملًا مؤثِّرًا وجوهريًا في التركيبة الفكريّة التي نظّر لها أدونيس. وهو قد بدأ بقراءة التحوّل من الشعريّة العربيّة الشفويّة إلى الشعريّة العربيّة الجماليّة اعتمادًا على قراءة نصوصٍ لشعراء ومفكّرين صوفيين ومعتزليين وعقلانيين، دون الاخذ في الاعتبار التحوّلات الاجتماعية والفكريّة داخل إطار التحوّل، وانتهى إلى أن جوهر مفهوم الحداثة الشعريّة هو في الانتقال من الثابت إلى المتحوّل الدائم والمستمر، ومن ثمّ قدّم نموذجه الخاصّ في الإبداع والابتكار عبر البنية الشبكيّة التي تعمل على الإتيان بلغةٍ جديدة تفصل بين الدال والمدلول كإرهاصةٍ للتحوّل إلى مدلولات جديدة، وبشكلٍ شبكيّ أو شجريّ يعمل على احتواء كل شيءٍ في ذات اللحظة، وتقديم معرفةٍ غامضة يمكن تأويلها لتقول كل شيء.
غير أننا رأينا قدرًا من الغموض في النموذج الشعري الشبكيّ الذي قدّمه أتى من تأثرٍ واضحٍ بالصوفيّة والسريالية، إدّى في النهاية إلى انعزل الشعر، وإلى فقده مساحتهِ الاجتماعيةّ والثقافية المهمةّ. كذلك عمل النموذج الفكريّ الذي قدّمه أدونيس متأثِّرًا بالنموذج الفكريّ الحداثيّ الأوروبيّ؛ إلى موضعة هذا النموذج في سياق المجتمع الحديث، ودون الاعتبار لدور المتلقيّ، أو المقاومة التي ستنتج في الحقل الثقافي الشعريّ ضد هذا التسارع الشعريّ، وهو ما قد يُنتج صراعًا بين الشاعر والمتلقيّ، أو انعزالا للشاعر بمشروعه بعيدًا عن المتلقيّ.
المصادر:
[1] أدونيس، الثابت والمتحوّل 4، (بيروت، دار الساقي، ب.ت)، صـ266. [2] آلان تورين، نقد الحداثة، تر: أنور مغيث، (القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1997)، صـ16. [3] آلان تورين، المرجع السابق، صـ23. [4] أحمد الشيباني، “مقدّمة المترجم”، في: أسوالد اشبنجلر، تدهور الحضارة الغربية ج1“، (بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، ب.ت)، صـ29. [5] محمد أركون، ورد في: محمد محفوظ، الإسلام، الغرب، وحوار المستقبل، (الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1998)، صـ 45. [6] اسماعيل ناشف، من محاضرة صفّية في منهج “علم الجمال”، بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الفصل الدراسيّ خريف 2016. [7] فرانسيس فوكوياما، “نهاية التاريخ، والإنسان الأخير“، تر: فؤاد شاهين، جميل قاسم، رضا الشايبي، ( يبروت، مركز الإنماء القومي، 1993). [8] أدونيس، “الشعريّة والشفويّة الجاهليّة“، في: الشعريّة العربية، ط2، (بيروت، دار الآداب، 1989). [9] لمزيدٍ من التفاصيل حول الشعريّة الشفوية يمكن مراجعة بحثٍ سابق لنا: مُصطفى حسن، “بين الشعريّة الشفويّة والشعريّة الكتابية“، بحث مقّدم لمادّة “علم الجمال” – معهد الدوحة للدراسات العُليا. [10] أدونيس، الشعريةّ العربية، مرجع سابق، صـ 31. [11] أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، (بيروت، دار الآداب، ب.ت.)، صـ 24. [12] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ42. [13] نسجِّل هنا تحفُّظنا على ما بُنى بعد ذلك على هذه النقطة التي يتناولها أدونيس دون التفرقة بين مصطلحيّ الإحداث أو التحديث، وبين الحداثة بمفهومها الأوروبيّ الحديث؛ إذ نرى أن الحداثة –كمفهوم عامل وشامل- يختلف عن الإحداث الذي يتناوله أدونيس هنا بمعنى الإبتكار أو التجديد. وهو ما يعتبره أدونيس أول لحظات الحداثة العربيّة. ونحنُ نتحفّظ تجاه هذا الخلط؛ كما سيلي لاحقًا. [14] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ44. [15] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ45. [16] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ55. [17] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ60. [18] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ78. [19] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ 83. [20] أدونيس، الثابت والمتحوّل بحث في الإبداع والاتّباع عند العرب – الجزء الرابع، (بيروت، دار الساقي، 1994)، صـ53. [21] أدونيس، الثابت والمتحوّل بحث في الإبداع والاتّباع عند العرب – الجزء الأول، ط7، (بيروت، دار الساقي، 1994)، صـ15 [22] أدونيس، الثابت والمتحوّل 4، مرجع سابق. [23] أدونيس، الشعريّة العربية، مرجع سابق، صـ90-95. [24] أدونيس، من حوارٍ مع أدونيس، مجلّة عيون، ( ليون، منشورات الجمل، العدد 6، السنة 3، 1998)، أجرى الحوار؛ عزمي عبد الوهاب، مهدي مُصطفى. [25] أدونيس، وقت بين الرماد والورد، مجموعة شعريّة، (بيروت، دار العودة، ب.ت). [26] أدونيس، الثابت والمتحوّل بحث في الإبداع والاتّباع عند العرب-الجزء الثالث، (بيروت، دار الساقي، ب.ت)، صـ 265. [27] أدونيس، الثابت والمتحوّل 3، مرجع سابق، صـ117-120. [28] أدونيس، النص القرآني وأفاق الكتابة، مرجع سابق، صـ75. [29] أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، مرجع سابق، صـ68. [30] عبد القادر محمد مرزاق، مشروع أدونيس الفكري والإبداعي رؤية معرفيّة، (القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ب.ت.)، صـ380. [31] أدونيس، الثابت والمتحول 3، مرجع سابق، صـ315. [32] صلاح فضل، أساليب الشعريّة المعاصرة، (بيروت، دار الآداب، ب.ت)، صـ29-30. [33] أدونيس، الثابت والمتحوّل 4، مرجع سابق، صـ266. [34] أيمن الدسوقي، (دراسات تطبيقية في الأدب العربي الحديث في ضوء نظريات الأدب المعاصر)، ربيع 2016، معهد الدوحة للدراسات العُليا. [35] هارتموت روزا، “التسارع والاغتراب: نحو نظريّة نقديّة جديدة للحداثة المتأخّرة“، تر: كمال أبو منير، (الجزائر، مجلّة دراسات فلسفية، جامعة الجزائر، العدد 10، 2014) [36] صلاح فضل، مرجع سابق.
لمصطفى حسن
ساسة بوست/موقع الحداثة

